dreamnagd
عضو مؤسس

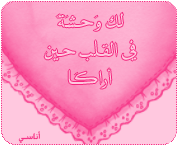
 MMS : MMS : 
الجنس : 
الابراج : 
الأبراج الصينية : 
عدد المساهمات : 810
نقاط : 13320
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 05/05/1967
تاريخ التسجيل : 02/12/2009
العمر : 57
الموقع : الرياض في قلب الجزيرة العربية
العمل/الترفيه : أعمال حرة
المزاج : رايق
 |  موضوع: كلمة الرئيس عند قبوله جائزة نوبل في أوسلو موضوع: كلمة الرئيس عند قبوله جائزة نوبل في أوسلو  الجمعة ديسمبر 11, 2009 1:42 pm الجمعة ديسمبر 11, 2009 1:42 pm | |
| كلمة الرئيس عند قبوله جائزة نوبل في أوسلو
(أوباما: جئت باحساس مليء بالتساؤلات العويصة عن العلاقة بين الحرب والسلام)
بداية النص
البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
10 كانون الأول/ديسمبر، 2009
كلمة الرئيس عند قبوله جائزة نوبل للسلام
مبنى بلدية أوسلو
أوسلو، النرويج
الساعة 1:44 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا
الرئيس: أصحاب الجلالة، أصحاب السمو الملكي، الموقرين أعضاء لجنة نوبل النرويجية، مواطني أميركا ومواطني العالم:
إنني أتسلم هذا الشرف
بامتنان عميق وتواضع جم. هذه جائزة تدل على أسمى تطلعاتنا- وهي أننا، مع
كل قساوة العالم ومشاقه، لسنا مجرد أسرى المصير. فأعمالنا ذات أهمية،
وتستطيع أن توجه التاريخ في اتجاه العدالة.
ومع ذلك فإنني سأكون
مقصرا إن لم أقر بالجدل الكبير الذي ولده قراركم السخي (ضحكات). ومرد ذلك
جزئيا هو أنني في البداية، ولست عند نهاية نشاطي على المسرح العالمي.
وبالمقارنة مع بعض من عمالقة التاريخ الذين تلقوا هذه الجائزة- شوايتزر
وكنغ؛ مارشال ومانديلا- فإن منجزاتي طفيفة. ثم هناك الرجال والنساء حول
العالم الذين تعرضوا للسجن والضرب في سعيهم من أجل العدالة؛ أولئك الذين
يعملون جاهدين في المنظمات الإنسانية للتخفيف من المعاناة؛ أولئك الملايين
الذين لا يقدرون حق قدرهم ولكن أعمالهم الشجاعة الهادئة وحنوهم وتراحمهم
تلهم أقسى المتشائمين الساخرين. وليس بوسعي أن أجادل الذين يرون أن هؤلاء
الرجال والنساء- بعضهم معروف، والبعض الآخر لا يعرفه إلا من يتلقى العون
منه- يستحقون هذا الشرف أكثر بكثير مني.
ولكن ربما كانت أبرز قضية
تحيط باستلامي الجائزة هي حقيقة أنني القائد الأعلى للقوات المسلحة في
دولة تخوض حربين، إحداهما تقترب تدريجيا من نهايتها. أما الحرب الأخرى فهي
نزاع لم تسع إليه أميركا؛ نزاع تشترك معنا فيه 42 دولة أخرى - من بينها
النرويج - في محاولة للدفاع عن أنفسنا وعن كل الأمم من هجمات أخرى.
ومع ذلك، فنحن في حرب،
وأنا مسؤول عن نشر آلاف من الأميركيين الشبان في ساحات الوغى في بلاد
نائية. بعضهم سيَقتُلون وبعضهم سيُقتَلون. ولذا فإنني جئت هنا بإحساس حاد
بالتكاليف الباهظة للنزاع المسلح- إحساس يفيض بأسئلة عويصة عن العلاقة بين
الحرب والسلام، وعن جهودنا لاستبدال أحدهما بالآخر.
وهذه الأسئلة ليست بأسئلة
جديدة. فالحروب، بشكل أو بآخر، ظهرت مع الإنسان الأول. في فجر التاريخ، لم
تتعرض أخلاقيتها للمساءلة والتشكيك؛ كانت مجرد حقيقة واقعة مثل القحط أو
الجفاف أو المرض—وكانت الحرب هي النمط الذي سعت به القبائل ثم الحضارات
إلى اكتساب السلطة وسوت به خلافاتها.
ومع مرور الزمن، وفيما
سعت أحكام القانون إلى السيطرة على العنف بين الجماعات، سعى أيضا الفلاسفة
ورجال الدين والساسة إلى تنظيم قوة الحرب المدمرة. وبزغ مفهوم "الحرب
العادلة" الذي يقول إن الحرب لا يجوز تبريرها إلا عندما تلبى شروط معينة:
أي إن كانت تُشن كملاذ أخير أو دفاعا عن النفس؛ أو إذا استخدمت القوة
بصورة متناسبة؛ أو إذا تم تجنيب المدنيين العنف، حيثما أمكن.
وبالطبع، نحن نعلم أن
مفهوم "الحرب العادلة" هذا نادرا ما روعي خلال معظم فترات التاريخ. فطاقة
البشر على استنباط طرق جديدة لقتل بعضهم بعضا مَعِين لا ينضب، وكذلك
طاقتنا على أن نستثني من الرحمة أولئك المختلفين عنا في المظهر أو الذين
يصلون لإله آخر. والحروب بين الجيوش أخذت تفسح المجال لحروب بين الأمم-
حروب شاملة طمس فيها الفرق بين المقاتلين والمدنيين. وفي فترة 30 سنة، غمر
حمام الدماء هذه القارة مرتين. وفي حين من الصعب أن نتصور قضية أعدل من
قضية إلحاق الهزيمة بالرايخ الثالث ودول المحور، فإن الحرب العالمية
الثانية كانت نزاعا فاق فيه العدد الإجمالي للقتلى من المدنيين عدد القتلى
من الجنود.
وفي أعقاب مثل هذا
الدمار، ومع إطلالة العصر النووي، أصبح واضحا للمنتصر والمهزوم على حد
سواء أن العالم بحاجة لمؤسسات تمنع اندلاع حرب عالمية أخرى. وهكذا، وبعد
ربع قرن من رفض مجلس الشيوخ الأميركي عصبة الأمم- وهي الفكرة التي من
أجلها نال وودرو ولسون هذه الجائزة- قادت أميركا العالم في بناء صرح لصون
السلام: مشروع مارشال والأمم المتحدة، وآليات تحكم شؤون الحرب، ومعاهدات
تحمي حقوق الإنسان، وتمنع الإبادة البشرية وتحد من أخطر الأسلحة.
هذه الجهود نجحت بسبل
شتى. نعم، شُنت حروب مروعة وارتُكبت فظائع. ولكن لم تندلع حرب عالمية
ثالثة. وانتهت الحرب الباردة بجموع مهللة تحطم جدارا. وربطت التجارة الشطر
الأكبر من العالم بعضه ببعض. وانتُشل البلايين من الناس من وهدة الفقر.
وتقدمت بخطى مترددة مثلٌ ومبادئ الحرية وحق تقرير المصير والمساواة وحكم
القانون. نحن ورثة صمود الأجيال السابقة وصبرها وبصيرتها، وهذا إرث يعتز
به وطني عن جدارة.
ومع ذلك، ونحن في أواخر
العقد الأول من قرن جديد، فإن هذا الصرح العريق يرزح تحت وطأة مخاطر
جديدة. لم يعد العالم يرتعد من احتمال اندلاع حرب بين دولتين عظميين
نوويتين ولكن الانتشار النووي قد يفاقم خطر الكارثة. والإرهاب وإن ظل
تكتيكا زمنا طويلا، لكن التكنولوجيا العصرية تتيح لحفنة من الرجال يستبد
بهم الغضب أن يقتلوا الأبرياء على نطاق مروع.
أضف إلى ذلك أن الحروب
بين الدول أخذت تفسح المجال بصورة مطردة لحروب داخل الدول. فظهور النزاعات
العرقية أو الطائفية بصورة متجددة؛ وتنامي الحركات الانفصالية، وحركات
التمرد، والدول الفاشلة- كل هذه الأمور توقع المدنيين بصورة متزايدة في
فوضى لا نهاية لها. ففي حروب يومنا الحاضر، يُقتل من المدنيين أكثر مما
يقتل من الجنود؛ وتُغرس بذور النزاعات المستقبلية، وتُدمر الاقتصاديات،
وتتشرذم المجتمعات المدنية بعد تمزقها، وتتضاعف أعداد اللاجئين ويتشوه
الأطفال.
إنني لا أحمل معي اليوم
حلا محددا لمشاكل الحرب. ولكن ما أعرفه هو أن مواجهة هذه التحديات سوف
تتطلب نفس الرؤيا والعمل الشاق والمثابرة التي تحلى بها أولئك الرجال
والنساء الذين تصرفوا بجرأة وجسارة بالغتين قبل عقود من الزمن. وسوف تتطلب
منا أن نفكر بطرق مختلفة إزاء مفاهيم الحرب العادلة وضرورات السلام العادل.
وينبغي علينا أن نبدأ
بالاعتراف بالحقيقة المرة: إننا لن نستأصل كل النزاعات العنيفة في حياتنا.
ستكون هناك أوقات حينما تجد الدول- سواء منفردة أو مجتمعة- أن استخدام
القوة ليس فقط ضروريا بل له ما يبرره أخلاقيا.
أقول هذا وأنا واع لما
قاله مارتن لوثر كينغ الابن في هذا الاحتفال ذاته قبل سنوات عديدة وهو أن
– "العنف لا يجلب السلام الدائم أبدا. إنه لا يحل أي مشكلة اجتماعية: فهو
يخلق مجرد مشاكل جديدة وأكثر تعقيدا." وأنا كواحد يقف هنا كنتيجة مباشرة
للعمل الذي كرس الدكتور كينغ له حياته، أنا شاهد حي على القوة المعنوية
للاعنف. وأنا أعلم أنه ما من شيء ضعيف وما من شيء سلبي وما من شيء ساذج في
عقيدة غاندي وكينغ.
لكنني كرئيس دولة أديت
اليمين لحماية بلدي والدفاع عنه لا أستطيع الاسترشاد بمثاليْهما فقط. ¦أنا
أواجه العالم كما هو، ولا يسعني الوقوف جامدا في وجه الأخطار التي تهدد
الشعب الأميركي. فلا يخطئن أحد في أن: الشر موجود فعلا في العالم. فحركة
اللاعنف ما كان ليكون بإمكانها أن توقف جيوش هتلر. والمفاوضات لا تقدر على
إقناع زعماء القاعدة بإلقاء أسلحتهم. والقول بأن القوة قد تكون ضرورية
أحيانا ليس دعوة للتشكك الساخر–بل هو إدراك للتاريخ ونواحي قصور البشر
وحدود المعقول.
أنا أثير هذه النقطة،
أبدأ بهذه النقطة، لأن هناك ترددا عميقا في كثير من البلدان اليوم بالنسبة
للعمل العسكري أيا كان السبب. ويكون هذا مقرونا أحيانا بشك انفعالي تجاه
أميركا، القوة العسكرية العظمى الوحيدة في العالم.
لكنه ينبغي على العالم أن
يتذكر أنه لم تكن مجرد المؤسسات الدولية – ولا المعاهدات والبيانات- هي
فقط التي حققت الاستقرار في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ومهما
كانت الأخطاء التي ارتكبناها، فإن الحقيقة البسيطة الواضحة هي أن:
الولايات المتحدة الأميركية ساعدت في ضمان الأمن العالمي لأكثر من ستة
عقود من الزمن بدماء مواطنينا وقوة أسلحتنا. فخدمة رجالنا ونسائنا في
القوات المسلحة عززت السلام والرخاء، من ألمانيا إلى كوريا، ومكّنت
الديمقراطية من الترسخ في أماكن كالبلقان. فلقد حملنا هذا العبء لا لأننا
نريد فرض إرادتنا. فعلنا ذلك انطلاقا من مصلحة ذاتية مستنيرة، لأننا نسعى
في سبيل مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا ونؤمن بأن حياتهم ستكون أفضل إذا
استطاع أبناء وأحفاد الآخرين أن يعيشوا في حرية ورخاء.
إذن نعم، إن لأدوات الحرب
دورا تلعبه في الحفاظ على السلام. ومع ذلك، فإنه ينبغي لهذه الحقيقة أن
تتعايش مع حقيقة أخرى وهي أنه – مهما كانت الحرب مبرَّرة، فهي تنذر بمأساة
إنسانية. صحيح أن شجاعة الجندي وتضحيته مفعمتان بالمجد وتعبران عن الولاء
للوطن وللقضية ولرفاق السلاح، لكن الحرب بحد ذاتها ليست عملا مجيدا، ويجب
علينا ألا نشيد بها باعتبارها كذلك على الإطلاق.
وهكذا فإن جزءا من التحدي
الذي نواجهه هو التوفيق بين هاتين الحقيقتين اللتين تبدوان أنهما لا توافق
بينهما، وهما أن الحرب ضرورية أحيانا؛ وأن الحرب، عند مستوى ما، تكون
تعبيرا عن الحماقة الإنسانية. صحيح أنه ينبغي علينا أن نوجه جهدنا نحو
المهمة التي دعا إليها الرئيس كينيدي منذ زمن طويل. قال "دعونا نركز
اهتمامنا على سلام يكون عمليا أكثر، وأكثر قابلية للتحقيق لا على أساس
ثورة مفاجئة في الطبيعة الإنسانية، وإنما على التطور التدريجي للمؤسسات
الإنسانية." تطور تدريجي للمؤسسات الإنسانية.
فما هو الشكل الذي يمكن أن يكون عليه هذا التطور؟ وما الذي يمكن أن تكونه تلك الخطوات العملية؟
بداية، أعتقد أنه ينبغي
على كل الدول – قويها وضعيفها على السواء – أن تلتزم بالمعايير التي تحكم
استخدام القوة. وأنا – شأني شأن أي رئيس دولة – أحتفظ بحق التصرف من جانب
واحد عند الضرورة للدفاع عن بلدي. ومع ذلك، فأنا على قناعة بأن الالتزام
بالمعايير، المعايير الدولية، يقوّي أولئك الذين يلتزمون بها ويعزل –
ويضعف – أولئك الذين لا يفعلون.
لقد احتشد العالم مع
أميركا على أثر هجمات 11 أيلول/سبتمبر ولا يزال يدعم جهودنا في أفغانستان
وذلك بسبب هول تلك الهجمات الطائشة واعترافا بمبدأ الدفاع عن النفس.
وبالمثل، أقر العالم بالحاجة إلى التصدي لصدام حسين عندما غزا الكويت –
فكان ذاك إجماعا بعث برسالة واضحة للجميع عن ثمن العدوان.
علاوة على ذلك، لا تستطيع
أميركا، ولا أي دولة، الإصرار على أن يتبع الآخرون قواعد الطريق إذا نحن
أنفسنا رفضنا اتباعها. لأننا عندما نرفض يمكن أن تبدو أعمالنا اعتباطية
وتنتقص من شرعية التدخل في المستقبل – مهما كان مبررا.
تصبح لهذا أهمية خاصة
عندما يمتد الغرض من العمل العسكري إلى أبعد من الدفاع عن النفس أو الدفاع
عن دولة ما ضد معتد. ونحن جميعا نواجه أكثر فأكثر أسئلة صعبة حول كيفية
تجنب مقتل المدنيين على أيدي حكوماتهم أو وقف حرب أهلية يمكن أن يجتاح
عنفها ومعاناتها منطقة بأسرها.
أعتقد أن بالإمكان تبرير القوة
على أسس إنسانية كما كان الحال في البلقان أو في أماكن أخرى جرّحتها
الحرب. فعدم العمل يمزق ضمائرنا ويمكن أن يؤدي إلى تدخل أكثر تكلفة فيما بعد. لهذا السبب يجب على كل الدول المسؤولة أن تتبنى الدور الذي تستطيع القوات العسكرية أن تلعبه في حفظ السلام بتفويض واضح.
إن التزام أميركا بأمن
العالم لن يتزعزع أبدا. لكن أميركا، في عالم تتوزع وتتباعد فيه الأخطار
وتتعقد فيه المهام، لا تستطيع العمل وحدها. فأميركا وحدها لا تستطيع تأمين
السلام. وهذا صحيح في أفغانستان. هذا صحيح في الدول الفاشلة كالصومال حيث
انضمت المجاعة والمعاناة الإنسانية إلى الإرهاب والقرصنة. ومن المحزن أن
ذلك سيبقى صحيحا بالنسبة للمناطق غير المستقرة لسنوات طويلة قادمة.
يدلل قادة بلدان منظمة
حلف شمال الأطلسي وجنودها وغيرهم من الأصدقاء والحلفاء على هذه الحقيقة من
خلال القدرة والشجاعة اللتين أظهروهما في أفغانستان. غير أن هناك في كثير
من البلدان انفصالا بين جهود أولئك الذين يخدمون وبين تردد الجمهور الأعم.
أنا أتفهم السبب في عدم شعبية الحرب، لكنني أعرف هذا أيضا وهو: أن
الاعتقاد بأن السلام أمر مستحب ، نادرا ما يكون كافيا لتحقيقه. فالسلام
يتطلب مسؤولية. السلام يقتضي تضحية. ولذا يجب علينا أن نقوّي الأمم
المتحدة ونعزز المحافظة على السلام الإقليمي ولا نترك تلك المهمة لعدد
قليل من البلدان. ولهذا السبب نحن نكرم أولئك الذين يعودون إلى الوطن من
مهمات حفظ السلام والتدريب في الخارج، في أوسلو وروما وأوتاوا وسيدني، وفي
داكا وكيغالي – نحن نكرمهم لا كصانعي حرب، بل كصانعين للسلام.
دعوني أذكر نقطة أخيرة
بالنسبة لاستخدام القوة. يجب علينا أيضا، حتى ونحن نتخذ القرارات الصعبة
بالذهاب إلى الحرب، أن نفكر بجلاء كيف نخوضها. ولجنة نوبل أدركت هذه
الحقيقة عند منحها أول جائزة للسلام لهنري دونانت، مؤسس الصليب الأحمر،
والقوة الدافعة وراء اتفاقيات جنيف.
وحيث تكون القوة ضرورية،
فإن لدينا مصلحة استراتيجية وأخلاقية في إلزام أنفسنا بقواعد سلوك معينة.
وحتى في الوقت الذي نواجه فيه خصما شرسا لا يلتزم بأية قواعد، فإنني أعتقد
أنه يجب على الولايات المتحدة الأميركية أن تكون رائدة في التمسك بمعايير
سلوك الحرب. وهذا ما يميزنا عن أولئك الذين نقاتلهم. وهذا هو مصدر قوتنا.
وهذا هو السبب في أنني حظرت التعذيب. وهذا هو السبب في أنني أمرت بإغلاق
سجن غوانتانامو. وهذا هو السبب في أنني قد أكدت من جديد التزام أميركا
بالتقيد باتفاقيات جنيف. إننا نفقد أنفسنا عندما نعرّض للخطر المُثُل
العليا ذاتها التي نحارب من أجل الدفاع عنها. (تصفيق) وإننا نكرم تلك
المثل من خلال التمسك بها ليس فقط حينما يكون من السهل فعل ذلك، ولكن أيضا
عندما يكون القيام بذلك أمرا صعبا.
لقد تحدثت عن المسائل
التي يجب أن تشغل عقولنا وقلوبنا حين نختار شن الحرب. ولكن اسمحوا لي أن
أنتقل الآن إلى جهودنا الرامية إلى تجنب هذه الاختيارات المأساوية والتحدث
عن ثلاث طرق يمكننا من خلالها بناء سلام عادل ودائم.
أولا، بالنسبة للتعامل مع
تلك الدول التي تنتهك القواعد والقوانين، أعتقد أنه يجب علينا تطوير بدائل
للعنف تكون صارمة بما فيه الكفاية لتغيير السلوك - لأننا إذا ما أردنا
تحقيق سلام دائم، عندها يجب يكون لكلمة المجتمع الدولي معنى. فتلك الأنظمة
التي تخرق القواعد يجب أن تتحمل المسؤولية. والعقوبات يجب أن تترتب عليها
تكلفة حقيقية. والعناد يجب أن يواجه بضغوط متزايدة - ومثل هذه الضغوط لن
توجد إلا حينما يتضافر العالم ويقف صفا واحدا.
ومن الأمثلة المهمة على
ذلك الجهود المبذولة الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، والسعي من
أجل تحقيق عالم خال منها. ففي منتصف القرن الماضي، وافقت الدول على
الالتزام بمعاهدة كانت الاتفاق فيها واضحا وهو: أن جميع الدول لها حق في
الحصول على الطاقة النووية السلمية؛ وتلك الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية
سوف تتخلى عن مسعاها؛ والدول التي تمتلك أسلحة نووية سوف تعمل من أجل نزع
هذه الأسلحة. وأنا ملتزم بالتمسك بهذه المعاهدة. فهي تشكل نقطة محورية في
سياستي الخارجية. وأنا أعمل مع الرئيس ميدفيديف للحد من مخزون الأسلحة
النووية التي بحوزة أميركا وروسيا.
ولكن من اللازم علينا
جميعا أيضا أن نصر على أن دولا مثل إيران وكوريا الشمالية لا تتلاعب
بالنظام. إن أولئك الذين يدّعون أنهم يحترمون القانون الدولي لا يمكن أن
يغضوا الطرف عندما يُضرب بتلك القوانين عرض الحائط. وأولئك الذين يحرصون
على أمنهم لا يمكنهم أن يتجاهلوا خطر حدوث سباق تسلح في الشرق الأوسط أو
شرق آسيا. وأولئك الذين يريدون السلام لا يمكنهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي
حين تسلح الدول الأخرى نفسها لحرب نووية.
وينطبق المبدأ نفسه على
أولئك الذين ينتهكون القوانين الدولية بارتكاب أعمال وحشية ضد شعوبهم.
فعندما تُرتكب إبادة جماعية في دارفور، واغتصاب بشكل منتظم في الكونغو،
وقمع في بورما - يجب أن تكون لهذه الأعمال عواقب. نعم، يجب الدخول في
حوار؛ نعم، يجب ممارسة الدبلوماسية - ولكن يتحتم أن تكون هناك عواقب عندما
تفشل هذه التدابير. وكلما كان تضافرنا معا وثيقا بدرجة أقوى ، كلما قل
احتمال أن نواجه الخيار بين التدخل العسكري أوالتواطؤ مع القمع.
وهذا يقودني إلى النقطة
الثانية - وهي طبيعة السلام الذي نسعى إليه. إن السلام ليس مجرد غياب
النزاع أو الصراع الظاهر. فالسلام العادل الوحيد الذي سيدوم حقا هو السلام
الذي يقوم على الحقوق المتأصلة والكرامة لكل فرد.
وهذه الرؤية كانت هي
الدافع لمن وضعوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية
الثانية. ففي أعقاب الدمار، أدرك معدو الوثيقة أنه إذا لم تتم حماية حقوق
الإنسان، فإن السلام لن يعدو كونه وعدا أجوف.
ومع ذلك فإنه يتم في
الكثير من الأحيان تجاهل هذه الكلمات. فبالنسبة لبعض البلدان، يُعتبر عدم
احترام حقوق الإنسان أمرا يغفره الإيحاء الكاذب بأن هذه مبادئ غربية
ودخيلة نوعا ما على الثقافات المحلية، أو على مراحل التنمية في البلاد.
وداخل أميركا، يوجد منذ أمد طويل توتر بين أولئك الذين يصفون أنفسهم
بالواقعيين وبين المثاليين - وهو توتر يوحي بخيار واضح بين السعي الضيق من
أجل المصالح أو شن حملة لا نهاية لها لفرض قيمنا في جميع أنحاء العالم.
وإنني أرفض هذه الخيارات.
وأعتقد أن السلام لا يستقر في الأماكن التي يحرم فيها المواطنون من حقهم
في التعبير بحرية أو ممارسة العبادة كما يشاءون؛ واختيار زعمائهم أو
التجمع دون خوف. إن المظالم المكبوتة تتقرح، وقمع الهوية القبلية والدينية
يمكن أن يؤدي إلى العنف. ونحن نعلم أيضا أن العكس هو الصحيح. فلم تنعم
أوروبا بالسلام إلا حين أصبحت حرة في النهاية. إن أميركا لم تشن أبدا حربا
ضد دولة ديمقراطية، وأقرب الدول الصديقة لنا هي الدول التي تحمي حقوق
مواطنيها. ومهما كان التعريف قاسيا، فإنه لا مصالح أميركا - ولا مصالح
العالم – تستفيد من حرمان البشر من تطلعاتهم.
ولذا حتى حين نحترم
الثقافة والتقاليد الفريدة للبلدان المختلفة، فإن أميركا ستظل على الدوام
صوتا يدافع عن تلك التطلعات التي هي حقوق عالمية. وسوف نكون شهودا على
الكرامة الهادئة للمصلحين من أمثال أونغ سانغ سو تشي؛ وعلى شجاعة
الزمبابويين الذين أدلوا بأصواتهم رغم تعرضهم للضرب؛ وعلى المئات من
الآلاف الذين خرجوا في تظاهرات صامتة عبر شوارع إيران؛ وهذا من الدلالات
العميقة على أن زعماء هذه الحكومات يخشون تطلعات شعوبهم أكثر من خشيتهم من
قوة أي دولة أخرى. ومن مسؤولية جميع الشعوب والدول الحرة أن توضح بجلاء
أننا نقف إلى جانب هذه الحركات-- حركات الأمل والتاريخ هذه.
اسمحوا لي أيضا أن أقول
ما يلي: إن تعزيز حقوق الإنسان لا يمكن أن يتحقق بالدعودة إليها فحسب. ففي
بعض الأحيان، يجب أن يكون ذلك مقرونا بدبلوماسية جادة ومضنية. وإنني أعلم
أن التعامل مع الأنظمة القمعية يفتقر إلى النقاء المريح للاستياء والسخط.
ولكنني أعلم أيضا أن العقوبات بدون التواصل - إدانات بدون مناقشات
ومداولات- لا يمكنها إلا أن تجعل الوضع الراهن المسبب للعجز والشلل يمضي
قدما. إنه لا يمكن لأي نظام قمعي أن يسلك طريقا جديدا ما لم يكن لديه خيار
الباب المفتوح.
وعلى ضوء أهوال الثورة
الثقافية، فقد بدا اجتماع نيكسون مع ماو وكأنه لقاء لا يمكن اغتفاره أو
تبريره. ومع ذلك فقد ساعد بالتأكيد في وضع الصين على درب مكّنها من انتشال
الملايين من مواطنيها من الفقر وربطهم بالمجتمعات المنفتحة. لقد أحدثت
مشاركة البابا يوحنا بولس الثاني في حوار مع بولندا مساحة ليس للكنيسة
الكاثوليكية فحسب، وإنما أيضا لزعماء نقابة العمال أمثال ليخ فاوينسا.
والجهود التي بذلها رونالد ريغان في سبيل الحد من التسلح وضبط الأسلحة
وقبوله للبريسترويكا (الانفتاح)، لم تحسن العلاقات مع الاتحاد السوفيتي
فحسب، ولكنها أيضا مكّنت المعارضين في عموم أوروبا الشرقية. لا توجد هنا
معادلة بسيطة. ولكننا يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق التوازن بين
العزل والمشاركة، وبين الضغوط والحوافز، حتى يتسنى الرقي بحقوق الإنسان
وكرامته على مر الزمن.
ثالثا، إن السلام العادل
لا يقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فحسب- وإنما يجب أن يشمل الأمن
الاقتصادي وإتاحة الفرص. لأن السلام الحقيقي لا ينحصر في التحرر من الخوف،
وإنما التحرر من العَوَز.
ومن الحقيقي بدون أي شك،
أن التنمية نادرا ما تتأصل جذورها في غياب الأمن؛ ومن الحقيقي أيضا أن
الأمن لا يكون موجودا أينما لا يتوفر للبشر ما يكفي من الغذاء أو المياه
النقية أو الدواء أو المأوى الذي يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة. وهو لا
يكون موجودا حينما لا يستطيع الأبناء أن يطمحوا في الحصول على تعليم جيد
أو فرصة عمل لدعم الأسرة. إن غياب الأمل يمكن أن ينخر في المجتمع من
الداخل.
وهذا هو السبب في أن
مساعدة المزارعين على إطعام شعوبهم- أو مساعدة الدول على تعليم أبنائها
ورعاية مرضاها- ليس من قبيل الإحسان المحض. وهو أيضا السبب في ضرورة أن
يتكاتف العالم لمواجهة تغير المناخ. ونادرا ما يكون هناك خلاف علمي على
أننا إن لم نفعل أي شيء، فإننا سنواجه مزيدا من الجفاف والمجاعات والنزوح
بأعداد كبيرة مما سيغذي المزيد من النزاعات والحروب لعقود طويلة. ولهذا
السبب فإن الدعوة إلى اتخاذ إجراء قوي شامل لا توجَّه من الناشطين في
الدعوة للمحافظة على البيئة والعلماء فحسب، وإنما من القادة العسكريين
أيضا في بلدي وفي دول أخرى الذين يدركون أن أمننا المشترك أصبح في كفة
الميزان.
لذا فإن الاتفاقيات بين
الدول، والمؤسسات القوية، ودعم حقوق الإنسان، والاستثمار في التنمية، كلها
عناصر حيوية من أجل تحقيق التطور الذي تكلم عنه الرئيس كينيدي. ورغم ذلك
فإنني لا أعتقد أنه ستكون لدينا الإرادة، ولا التصميم، ولا القوة الثابتة،
لاستكمال هذه المهمة بدون إضافة شيء آخر، ألا وهو التوسع المستمر في نطاق
معتقداتنا الأخلاقية؛ والإصرار على أن هناك شيئا مشتركا بيننا جميعا غير
قابل للنقصان أو الاختزال.
وفيما يصبح العالم أصغر فأصغر، فإنكم
قد تفكّرون في أنه سيكون من السهل على بني البشر إدراك مدى التشابه فيما
بيننا؛ وأن يدركوا أننا نسعى جميعا في الأساس لتحقيق الأشياء نفسها؛ وأننا جميعا نأمل في أن تُتاح لنا الفرصة لكي نحيا حياتنا في ظل قدر من السعادة والإنجاز لأنفسنا ولعائلاتنا.
ورغم ذلك، فبطريقة ما، إن
أخذنا في الاعتبار الوقع السريع المسبب للدوار في الاتجاه إلى العولمة،
وما تؤدي إليه الحداثة من تساوي كل الثقافات، فربما تسري – وهو ما لا يمثل
أي مفاجأة – الخشية بين الناس من فقدان ما يعتزون به في هوياتهم الخاصة-
أي العرق والقبيلة وربما بالدرجة القصوى دينهم وعقيدتهم. وفي بعض المناطق
أدت هذه الخشية إلى الصراعات والحروب. وفي بعض الأوقات سرى إحساس بأننا
نتحرك نحو الوراء. وهو ما نراه في الشرق الأوسط، حيث تزداد صلابة النزاع
بين العرب واليهود، على ما يبدو. ونراه في الشعوب التي تمزقت حسب الخطوط
القبلية.
أما الخطورة القصوى ،
فإننا نراها في الطريقة التي يُستخدم بها الدين لتبرير قتل الأبرياء على
يد أولئك الذين شوهوا وأساءوا إلى دين الإسلام العظيم، والذين هاجموا بلدي
من أفغانستان. وأولئك المتطرفون ليسوا أول من قتل مستخدما اسم الله؛
فبشاعة الحملات الصليبية مسجلة بإسهاب. ولكنهم يذكروننا بأن أي حرب مقدسة
لا يمكن أن تكون حربا عادلة على الإطلاق. لأنك إن كنت تؤمن حقيقة بأنك
تنفذ إرادة إلهية، فليست هناك ضرورة لأي ضبط نفس- لا ضرورة لتجنيب أم
حامل، أو متخصص في الرعاية الطبية، أو في الصليب الأحمر، أو حتى شخص يؤمن
بعقيدتك. وهذه النظرة الملتوية للعقيدة الدينية لا تقتصر على كونها منافية
لفكرة السلام، وإنما هي في اعتقادي تتنافى مع جوهر الإيمان – لأن القاعدة
الكامنة في قلب كل عقيدة من العقائد الكبرى تتمثل في أن نتعامل مع الآخرين
كما نود أن يتعاملوا معنا.
والتمسك بقانون المحبة
هذا كان دائما لب النضال للطبيعة البشرية. لأننا غير معصومين من الخطأ.
ولأننا نرتكب أخطاء، ونقع ضحايا لإغراءات الزهو والقوة وأحيانا الشر. وحتى
الذين يضمرون أحسن النوايا من بيننا سيخفقون في بعض الأحيان في تصحيح
الأخطاء أمامنا.
ولكن لا ينبغي علينا أن
نتصور أن الطبيعة البشرية كاملة لدرجة أن يسارونا الاعتقاد في أن أحوال
البشر يمكن إصلاحها وتوصيلها لدرجة الكمال. ولا ينبغي علينا أن نعيش في
عالم مثالي لكي نستمر في محاولة تحقيق تلك المثل والمبادئ التي تجعل
العالم مكانا أفضل. فعدم اللجوء إلى العنف الذي مارسه رجال مثل غاندي
وكينغ قد لا يكون عمليا أو ممكنا في كل الظروف والأحوال، ولكن المحبة التي
دعوا إليها- وإيمانهم الراسخ بتقدم البشر- يجب أن يكون دائما النجم الهادي
المرشد لنا في رحلتنا.
لأننا إن فقدنا ذلك
الإيمان- إذا استبعدناه كفكرة سخيفة أو ساذجة؛ وإذا فصلناه عن القرارات
التي نتخذها بشأن قضايا الحرب والسلام- فإننا نكون فقدنا أفضل ما في
البشرية. نكون فقدنا الشعور بإمكانياتنا. ونكون فقدنا بوصلتنا الأخلاقية.
وكما فعلت أجيال قبلنا،
فإنه ينبغي علينا أن نرفض مستقبلا كهذا. وكما قال الدكتور كينغ في مثل هذه
المناسبة قبل سنوات عديدة، "إنني أرفض تقبل فكرة اليأس كرد نهائي على ما
يثير الالتباسات في التاريخ. وأرفض تقبل فكرة أن "الحالة الراهنة" لأحوال
الإنسان تجعله غير قادر معنويا وأخلاقيا على التوصل إلى الحالة التي
"ينبغي أن تكون عليها" التي تواجهه إلى الأبد."
لنتواصل مع العالم الذي ينبغي أن يكون- الذي يومض من الطبيعة الأسمى من طبيعة البشر التي ما زالت تتحرك داخل أرواحنا جميعا. (تصفيق)
ففي مكان ما اليوم، في
مكان وزمان ما، في العالم كما هو الآن، يوجد جندي يعرف أنه قد يواجه
نيرانا لا يستطيع التغلب عليها، ولكنه يقف صامدا للحفاظ على السلام. وفي
مكان ما، في هذا العالم، توجد محتجة شابة تتوقع ارتكاب حكومتها أعمالا
وحشية، ولكن لديها الشجاعة للخروج في مسيرة. وفي مكان ما اليوم، توجد أم
تواجه الفقر المدقع ما زالت تكرّس الوقت لتعليم طفلها، وتجمع بجهد شديد ما
تستطيع الحصول عليه من نقود قليلة لترسل ابنها إلى المدرسة- لأنها تؤمن
بأن العالم القاسي ما زال فيه مكان لأحلام هذا الطفل.
دعونا نحذو حذوهم.
وبمقدورنا أن نعترف بأن القهر سيظل دائما بين ظهرانينا، ولكننا سنظل نكافح
من أجل تحقيق العدل. وبمقدورنا أن نسلّم بالآلام الموجعة للحرمان ، ومع
ذلك نواصل الكفاح من أجل الكرامة. ويمكننا أن ندرك بوضوح أنه ستكون هناك
حرب، ولكننا نظل نكافح من أجل السلام. يمكننا أن نفعل ذلك –لأن هذه هي
حكاية التقدم الإنساني؛ وهذا هو أمل العالم كله؛ وفي لحظة التحدي هذه، يجب
أن تكون هذه هي مهمتنا على ظهر الكرة الأرضية.
أشكركم شكرا جزيلا. (تصفيق.)
الساعة 2:20 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا
نهاية النص
**** | |
|
